منذ البداية روّجت إسرائيل لاعتبار هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، الذي شنّته “حماس” على مستوطنات “غلاف غزة”، وكأنّه نسيج وحده، بنزع صلته من سياق التاريخ والجغرافيا والسياسة، وكعدوان من الأشرار على الأخيار، وبوصفه بمثابة 11 أيلول (سبتمبر) خاصتها، مع وصم “حماس” كـ”داعش”، مصوّرة نفسها ضحية مطلقة، تتمتع بحق الدفاع عن نفسها، بكل الوسائل، ومن دون حساب، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، ضدّ فلسطينيي غزة، بوصفهم الحاضن لحركة “حماس”، بما في ذلك قطع الماء والكهرباء والدواء والغذاء وتدمير البيوت والمستشفيات والمدارس والبني التحتية، وتجريدهم من الأنسنة، أي بالتعامل معهم كمتوحشين، أو كبشر مقيمين ليس لهم أي حقوق.
طبعاً لم تصمد تلك السردية عن حرب غزة، إذ سرعان ما انقشعت عن ادّعاءات، وأكاذيب، وتزوير للحقائق، بدلالة الحراكات الشعبية، غير المسبوقة، في الدول الغربية، المتمثلة بعرائض للحكومات وبيانات واعتصامات وتظاهرات حاشدة، شهدتها عواصم ومدن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وإيطاليا وهولندا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا، لإدانة حرب إسرائيل على غزة، ورفض ادعاءاتها، مع رفع أعلام فلسطينية، الأمر الذي فرض ضغوطاً أدّت إلى لجم اندفاعة بعض الحكومات الغربية التي أبدت دعماً مطلقاً لإسرائيل في حرب الإبادة التي شنّتها على الفلسطينيين، بدعوى الدفاع عن النفس.
ثمة عوامل عديدة أسهمت في صعود وانتشار تلك الحراكات لصالح الفلسطينيين، بأقوى من أية فترة مضت، يكمن أهمها في الآتي:
أولاً، انكشاف، أو انفضاح حقيقة الادّعاءات الإسرائيلية، وتلاعب إسرائيل بالرأي العام العالمي، إذ تبين، مثلاً، أنّ القتلى الإسرائيليين في الحفل الشبابي الفني كانوا ضحية قصف طائرة عسكرية إسرائيلية، نتيجة الاضطراب الحاصل في الجيش الإسرائيلي، الذي أخذ بغتة بقوة الهجوم في أراضيه، وهي سابقة لم يعتد عليها، وذلك بحسب تقرير كشفته صحيفة “هآرتس”.
أيضاً، فإنّ كل الدعاية عن وجود أنفاق تستخدمها قيادة “حماس”، أو مقاتلوها، تحت المستشفيات، بخاصة تحت مستشفى “الشفاء”، والتي استخدمتها إسرائيل لتبرير تدميرها كل المنظومة الصحية في غزة، بينت عن محض أكاذيب، بعد تدمير واقتحام معظم المستشفيات، حتى أنّ ايهود باراك ذاته (رئيس الحكومة الأسبق) سفّه تلك الدعاية. يأتي ضمن ذلك أيضاً انكشاف التلفيقات الكاذبة عن التنكيل بالمحتجزين والمحتجزات والأسرى، والتي لم تثبت، لا سيما بعد الإفراج عن هؤلاء، إلى درجة اضطر معها الرئيس الأميركي جو بايدن للاعتذار عن اتهاماته السابقة.
ثانياً، أسهمت وسائط التواصل الاجتماعي، وعولمة وسائل الإعلام، في إيقاظ الضمير العالمي، وطرح تساؤلات، أخلاقية وسياسية عن معنى هذه الحرب، لاسيما مع انفضاح انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، وارتكابها جرائم حرب، وانتهاجها سياسة العقاب الجماعي، بدعوى الدفاع عن النفس، على مرأى من العالم كله. ففي 47 يوماً، من تلك المقتلة، ذهب 65 ألفاً من الفلسطينيين، بين شهيد وجريح ومفقود (تحت الركام) ضمنهم أكثر من 6 آلاف طفل، و4 آلاف امرأة، مع تدمير 60 في المئة من عمران غزة، وتشريد 1.3 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان غزة (2.2 مليون نسمة)، هذا مع قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عنهم، ومع كل الأهوال التي عاشها أطفال ونساء وشيوخ ومدنيي غزة أمام أنظار العالم، بل وبتغطية من بعض الدول.
ثالثاً، أسهمت بعض الشخصيات اليهودية المؤثرة، كإيلان بابيه وجوديث بتلر وجدعون ليفي ونورمان فنكلشتاين، وجماعات يهودية مثل “الصوت اليهودي الموحّد”، و”ليس باسمنا”، على سبيل المثال، في فضح الرواية الإسرائيلية، وتفنيد ادعاءاتها، في المقالات والبيانات والمشاركات التلفزيونية، والتي تمّ فيها وضع هجوم “حماس” ضمن سياقه، عن شعب طُرد من أرضه قبل 75 عاماً، وعانى من اللجوء، ثم وجد نفسه في معسكر اعتقال كبير اسمه قطاع غزة، وهو محروم من الهوية ومن فرص العيش بكرامة، ناهيك بتعمّد إسرائيل، كسجّان، الاعتداء عليه في سجنه. بل إنّ جدعون ليفي تعجّب من عرض إسرائيل ذاتها كضحية وحيدة، والتي تستغرب أن ينفجر الفلسطيني بوجهها، بسبب سياساتها. في حين أكّد ايلان بابيه وجوديث بتلر، أنّ القضية الفلسطينية لم توجد يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) فقط، وإنما وجدت في السياق الاستعماري، وسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل.
أيضاً، فقد شهد العالم أنّ ثمة جماعات يهودية، ومشاهير يهوداً، كتبوا عرائض الى حكوماتهم في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، يحتجون فيها على قمع حرّية الرأي للفلسطينيين، وعلى دعم حرب الإبادة ضدّهم، إضافة إلى مشاركتهم الواسعة، واللافتة في كل التظاهرات والاحتجاجات في الولايات المتحدة والدول الغربية؛ تحت شعار: “ليس باسمنا”، أي أنّ إسرائيل في حربها ضدّ الفلسطينيين لا تعبّر عن اليهود، وبات توصيف إسرائيل كدولة فصل عنصري متداولاً إسرائيلياً.
رابعاً، في هذه المرّة بدت قضية فلسطين كقضية تحرّر عالمي، بدلالة الانشقاق في موقف الحكومات الغربية، ثم بمراجعة بعض الحكومات لسياساتها الداعمة بالمطلق لإسرائيل (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، كما بدلالة الانشقاق الآخر الحاصل بين مواطني الدول الغربية ومواقف بعض الحكومات المؤيّدة لإسرائيل. ففي المحصلة باتت فلسطين كقضية تحرّر وعدالة ومساواة، في صلب القيم الإنسانية، التي يعتبرها الغرب رسالته إلى العالم، باعتبار هذا الموقف جزءاً من الدفاع عن حقوق الإنسان، وعن حق الجميع في الحرّية والعدالة والمساواة في الدول الغربية ذاتها، التي بات مواطنوها يشعرون أنّ تلك الحرّية تتآكل، في مسألة إسرائيل، كأنّها تابو، في تعبير عن رفضهم ادّعاء المساواة بين العداء للسامية والعداء للسياسات الوحشية والعنصرية الإسرائيلية، وكذلك في رفض اعتبار إسرائيل كضحية، في حين هي المتسببة بعذابات الفلسطينيين، الذين تحاول إخفاءهم، أو حرمانهم من مكانة الضحية، لتجنّب التبعات السياسية والقيمية والأخلاقية، المترتبة على حقهم كبشر، وضمنها حقّهم الطبيعي في الدفاع عن النفس، في رفض لمقولة غولدا مائير، التي قالت فيها مرّة: “لن أسامح الفلسطينيين لإجبارهم إيانا على قتل أطفالهم”.
طبعاً سيكون لكل تلك العوامل تداعياتها، القريبة والبعيدة، على صورة إسرائيل في الغرب، ونمط علاقاتها بالدول الغربية، كحكومات وكمجتمعات، بل إنّ ذلك سيطاول علاقتها بيهود العالم، وبالعكس.
وبالتأكيد، فإنّ كل ذلك ما كان ليحصل لولا صمود المقاتلين، في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية، وعدم تمكينها في السيطرة على غزة، ولولا عجز الجيش الإسرائيلي عن تحرير محتجز أو رهينة إسرائيلية واحدة، رغم كل الأهوال التي عانى منها الفلسطينيون.
النهار العربي

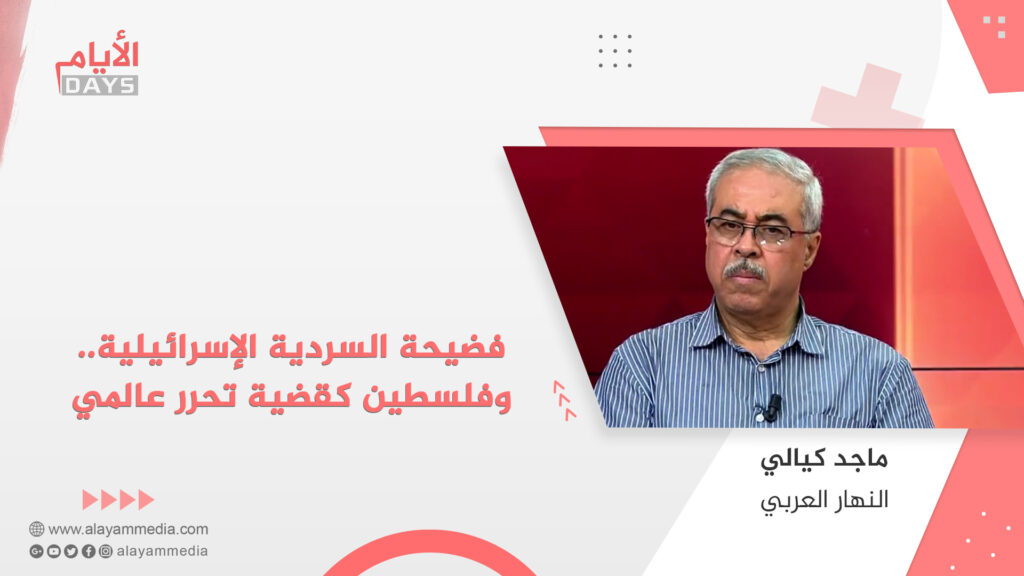



Comments are closed for this post.