مرت منطقتنا، خلال القرن الأخير، بأحداث جمة وتوالت عليها صدمات وحروب مهولة، قلبت شأنها رأسا على عقب ،وتركت فيها تصدعات لم تُرأب بعد وجروج لم تندمل إلى يومنا هذا.
لقد كانت هذه المساحة الجغرافية الشاسعة والتي تتميز بخصائص عديدة، محط أنظار واهتمام كل القوى التي راودها حلم حكم العالم والسيطرة عليه. فقد حظيت هذه الأرض، دونا عن غيرها، باهتمام كل حكيم و صالح، مثلما ابتليت بتسلط كل جبار وطامع.
حدث هذا منذ القدم. فهذه الجغرافيا مثقلة بتركات الماضي الغابر، وحكايا الأقوام الذين أقبلوا عليها بالحب والعطاء، فعمروها، والذين جاؤوها بالحقد والتسلط فخربوها. ثم أفضى كل منهم إلى قدره المحتوم طوعا أو كرها.
هذه البقعة التي تحمل في ثناياها أسرار كل من عبرها فخبأ فيها أمله وألمه، تبدو اليوم وكأنها تحمل بين صخورها العنيدة، وتحضن في سهولها الرحبة، أصوات تلك الأقوام. صرخاتهم وضحكاتهم وصهيل خيولهم وصليل سيوفهم، همساتهم وأحاديثهم..
هذه الأرض تبدو متعبة و منهكة، لكنها لا تزال تأبى الركوع والرضوخ للطغاة الذين يُخدعون فيظنون أن ما هي إلا ضربة واحدة فتكون تلك هي القاضة و يغنمون تلك الجميلة الأبية المثقلة بالأحمال والهموم. وكأن كلا منهم يقول: لقد تمردت قديما أمام من سبقوني من غزاة، فقد كنت فتية وقوية، لكنني أتيتك اليوم وقد خارت قواك ولم يبق لك حيل للصمود. فما إن يهوي عليها بضربته ظنا منه أنها ضربة النصر حتى ينكسر سيفه ويلوى معصمه. نعم فالذي يثقلها هو ما يجعلها متينة لا تهتز. ترى الأهوال حولها من كل مكان لكنها ثابتة تتألم بصمت وتشد على جرحها وتعيد زئيرها إلى أعماقها فلا يصدر إلا صوت مهيب يرهب الطامعين فيها.
ليتنا كنا قادرين على أن نتحدث إلى شجرها وحجرها وصخورها وأسوارها تلك، فتهمس في أذننا حكايات أولئك الأقوام وتروي لنا عن الذين أحبوها فحفظت ذكراهم والذين أبغضوها فرُدّوا على أعقابهم خاسرين. فلم يبلغنا من ذلك إلا القليل.
لكن بلغنا من أولئك الأقوام الذين حكموا العالم و ثبتوا حكمهم في هذه المنطقة صالحان وطالحان. أما الصالحان فهما النبي سليمان عليه السلام وذو القرنين. وأما الطالحان فهما النمرود وبختنصر. ثم جاء إليها بعدهم أقوام آخرون يجرون جحافل جيوشهم. فمنهم من جلب معه همجيته وحقده وفرغهما فيها وخرب عمرانها، ومنهم من أقبل عليها بحكمته وتحضره، فجعله علمه يدرك قيمتها ويصونها ويُنزِلها منزلة الإكرام والتبجيل فضمد جراحها وزاد على جمالها رونقا وثراء.
كان هذا حالها منذ القدم وإلى اليوم. فكل من أراد حكم العالم أيقن أن هذه المنطقة هي السبيل. من فاز بها نال القوة والمجد. وهذا يبدو جليا وواضحا من خلال مراجعة القرنين الأخيرين من التاريخ. فكل القوى الصاعدة التي ابتغت السيطرة والآفلة التي جاهدت من أجل البقاء، أقبلت كلها من الشرق والغرب تريد أن تحظى بهذه الجوهرة الثمينة. كل منهم جاء من بعيد يلحق الهزائم بعدوه ويراكم الانتصارات حتى بلغ المتصارعون ساحة المعركة الأخيرة والحاسمة التي ستحدد من يتربع على عرش العالم. فكل منهم يوقن أنه طالما لم ينلها سيبقى نصره منقوصا ولن يذكره التاريخ من بين أولئك الذين حكموا العالم.
لقد تصارعوا وعلا غبارهم حتى تبين الأمر وظهرت الغلبة للغرب الذي تقوده الولايات المتحدة. بل حتى ذلك الغرب حارب بعضه للسيطرة على المنطقة. لكن حينما كان أحد الأعداء أبعد في العرق والدين، بينما العدو الأقرب قد انتصر اصطف الأوروبيون إلى جانبه وأصبح منافسا وليس عدوا. وانتظم العالم بين كفتين: إحداهما لحاكم العالم وهو الولايات المتحدة التي ينضوي تحتها الغرب كله أي الأوروبيون، والأخرى هي الاتحاد السوفياتي الذي يتزعم الشرق، لكنه لا يحكم العالم لأنه لم يفز في المعركة الأخيرة. بل همه إزاحة الحاكم والانقضاض على مكانه.
وبين صراع الوحوش هذا، كانت شعوب هذه المنطقة كلها قد أنهكت بويلات الحروب والقتل، الحروب التي شنها الغزاة عليها، والحروب التي خاضها الغزاة فيما بينهم على أراضيها. وقد أصابها القهر والبؤس وقتل زعماؤها وقادة فكرها فأصبحت ممزقة تائهة مُجهّلة ومُفقّرة. وقد زاد هذا من مأساتها، إذ أن جزءً منها كان خاضعا للسيد الغربي، والآخر خاضع للسيد الشرقي. فهي تعاني تحت ظلم وتريد الخلاص منه. لكن لما أصابها من ذل وتشتت، أصبحت غير قادرة على الإدراك، لدرجة أنها تظن بأن خلاصها من سيد، هو في ارتمائها عند السيد الآخر الذي يمارس أيضا الظلم بحق إخوانها، دون أن يخطر على بالها حتى أن خيارا آخر قد يكون ممكنا، وهو أن تكون هي سيدة نفسها من جديد. لكن لا، هذا لم يكن ممكنا. لم تكن قادرة على التفكير بهذه الطريقة، لأنه كي يتمكن المرء من التفكير في أمر كهذا يجب أن يكون عقله حرا ويتخلص أولاً من الأغلال. لكن الذي يرزخ عقله تحت الاستعباد، يفكر في استبدال السيد وليس في التحرر.
مثال ساطع على هذا الوضع النفسي، ذكر في القرآن الكريم، فحين مكن الله النبي موسى عليه السلام من تحرير قومه من ظلم واستعباد فرعون لهم، وخرج بهم من مصر في رحلة نحو الكرامة والحرية، فمروا على قوم يعبدون آلهة مصنوعة، فطلبوا من نبيهم موسى أن يكون لهم آلهة كما لأولئك آلهة. يعني هم الذين أصبحوا أحرارا، يرون الذين يعبدون العباد خيرا منهم ويريدون تقليدهم. فهم لا يدركون سمو مكانتهم ويطلبون الذي هو أدنى، لأنهم لا يفهمون معنى الحرية ولا يستوعبونها أصلا.
لقد أصبح حال الكثير من الناس في منطقتنا هكذا، لا يخطر ببالهم أصلا التحرر بل يسعون إلى التغيير دون الخروج من إطار العبودية. وما يزيد بؤسهم بؤسا هو أن كلا منهم يمتدح السيد الذي يظلم أخاه ضدا في السيد الذي يظلمه هو. فكثير منهم لا يعلم ما يعانيه أخوه تحت حكم السيد الآخر. والبعض الآخر تطبعت نفسه بالسوء وأصبح مؤيدا لسيده بكل جوارحه، يتحمس من أجله ويطبل له. فقد قيل أن البعض حينما يمارس عليه السوء لا تكون ردة فعله طبيعية أي الرفض والحرص على مجابهة الظالم ومساندة المظلوم، بل يحصل العكس: يتطبع بسوء ظالمه ويمارسه على غيره.
فمثلا، كثير من الذين يقعون تحت حكم السيد الغربي الذي يتبنى الرأسمالية ينظرون بنظرة الإعجاب إلى السيد الشرقي الذي يحمل شعار الاشتراكية التي تدعي الدفاع عن الطبقات الكادحة ومحاربة الطبقية واستئثار فئة قليلة بالثروة. هذه الشعارات تثير إعجابهم وتلهب مشاعرهم فيقومون بالتهليل للاشتراكية وتوابعها ويرفعون شعارات النضال والثورة والعدالة والتمرد. وفي المقابل، الذين يقعون تحت حكم السيد الشرقي الذي يحمل هذه الشعارات البراقة يعانون في الواقع من القمع والاستبداد والبؤس. وبينما حالهم كذلك، يسمعون من هنا وهناك كلاما بأن الذين يعيشون تحت النظام الرأسمالي ينعمون بالغنى وحرية التعبير ويتمتعون بملذات كل شيء. فيرفعون شعارات الحرية والحقوق والديمقراطية ويهللون للسيد الغربي يبتغون الانتقال إلى العيش تحت سيادته.
وأغلب الظن أن الذين يؤيدون السيد الشرقي فئتان: منهم من يؤيده لأنه يكره سيده الذي استبد به وجعله يعاني ويُذَل وهو لا يعرف وجهه الحقيقي. ومنهم من يؤيده لأنه فعلا يقتنع به وتعجبه أيديولوجيته وهو يعلم وجهه الحقيقي. فالشرق لا يكشف عن حقيقة أيديولوجيته وأساليبه القمعية أمام الآخرين، بل دائما ما يخفي وحشيته، ويجتذب الناس بالشعارات البراقة التي من الطبيعي أن تستثير وتستنهض ذاك الضعيف المظلوم الذي لا يجد من يعبر عن ألمه ومعاناته. فيأتي ومن يمثله يصرخ بصرخاته المكتومة ويصبح متنفسه الوحيد وقدوته في كل شيء. لكي يسيطر هؤلآء على مجتمع ما، يستغلون هموم الناس وآلامهم ليجذبوا الناس إليهم. يبحثون عن الأمور الذي تثير حماسة الناس والمشاكل التي يعاني منها الناس في مجتمع ما، فيتبنونها ولا يؤلون جهدا في تحويلها إلى شعارات يرفعونها. فيصبحون في نظر البسطاء – وهم جزء كبير من الناس خاصة في المجتمعات التي تم تجهيلها والسيطرة على عقول الناس فيها – القدوة التي يحتذى بها ويسلمون عقولهم لهم دون معرفة حقيقتهم.
الكثير من الناس مثلا يؤيدون الاشتراكية كرها في النظام الرأسمالي الذي يحكمهم وهم بالفعل يعانون فيه من الفقر والفوارق الاجتماعية وغياب حقوق الطبقات الأكثر فقرا. لكنهم عاجزون عن التفكير في حل ثالث بسبب الانهزام النفسي الناجم عن الهزائم المتوالية وتقييد الفكر والعقل الذي خضعوا له، بينما قادة الفكر لديهم أبعدوا وهمشوا، فكبروا كجيل يتيم ليس لديه من يرشده ويبين له.
الفئة التي ترزخ تحت حكم السيد الغربي وتنظر بعين الإعجاب للسيد الشرقي، هي الأكبر، والغالب الأعم من منطقتنا ينضوي تحت هذه الفئة. مع الإشارة هنا إلى أن السيد الشرقي لم يعد موجودا بشكل فعلي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بل بقي فكره وأيديولوجيته وبعض القوى المحلية التي تحاول الاقتراب من بعضها البعض ،مع بقايا الإمبراطورية البائدة التي تسعى لاسترداد ما كان لها من قوة.
يظن للوهلة الأولى أن محاورة هذه الفئة وتوعيتها و تبيين حقيقة الأمر الذي تغفله سيجعلها تغير رأيها وتدرك حقيقة الأمر. لأن اتباعها لهذا الفكر لم يكن مبنيا على اطلاع كامل على الحقائق، بل كان مبنيا على رفض الظلم. فطرة هؤلاء سليمة لكن الظروف المحيطة بهم أدت بهم إلى نتائج خاطئة. وبالتالي تدارك الأمر يصبح سهلا هنا، إذ يكفي توضيح الأمر وتفسيره وإظهار الظلم الواقع على الآخرين. فإن كان سبب الاتباع هو رفض الظلم، فإن كشف الوجه الظالم لهذا الفكر يكفي لينفض القوم من حوله.
على أن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن الإنسان لديه جانب عاطفي قد يغلب على عقله فيدرك بعقله الحقيقة لكنه لا يتقبل الأمر عاطفيا لأنه توهم بأن هذا الفكر مثلا يمثل النضال والكفاح وقد أسعده ذلك أو على الأقل خفف من معاناته وكان متنفسا له، فلا يريد أن يعيش خيبة الأمل خاصة إن لم يكن البديل مطروحا وفورا.
الشاعر ناظم حكمت مثلاً. اتبع الفكر الشيوعي ليس اقتناعا تاما بهذا الفكر، بل بسبب حجم الاستبداد والظلم الذي عايشه في بلده في تلك الفترة. وهو رغم كل شيء اختار أن يعاني داخل بلده ولم يفر إلا حينما أيقن أن ثمة أمر كان يدبر له وكان يراد قتله. وحتى اختياره لمنفاه في الاتحاد السوفييتي لم يكن اختياريا. فهو أصلا هارب من نظام رأسمالي. فليس أمامه سوى الالتجاء إلى عدو ذلك النظام طلبا للحماية. وفي منفاه بقيت كتاباته وأشعاره تعبر عن حنينه وشوقه لبلده وثقافته حتى رحل إلى مثواه الأخير. لكن رفضه للاستبداد جعله يرفض امتداح ستالين فجر عليه ذلك غضب السلطة هناك.
الطامة الكبرى هي في الفئة الثانية التي تبنت هذا الفكر عن علم بالوحشية والإقصائية التي يحملها لأنها اقتنعت به بالفعل. فهؤلاء يحملون في داخلهم كل هذا السوء وهذه الاستبدادية وإقصاء المخالفين وقمعهم فوجدوا هذا الفكر يعبر عنهم. فهؤلاء لا يمكنك إقناعنهم، وهؤلاء يمارسون نفس أساليب النظام الشيوعي تجاه الأفراد. ما إن تبدأ في نقاشهم حتى يشبعونك بالشعارات البراقة وعبارات النضال والتمرد والكفاح وشيطنة الآخر والحط من قيمته. ويخيل إليك أنهم يرددونها بشكل تلقائي شعبوي ويكيلون الكلام بالمكيال وكأنه كيس شعير يبيعونه بالجملة. ولكن حينما ترد عليهم بالعقل والوقائع والكلام المبني على تحليل حقيقي قابل للإثبات، تراهم يتململون. وما إن تكثر جدالهم حتى يكشرون عن أنيابهم ويسقط عنهم ذاك القناع الذي يصورون أنفسهم به على أنهم نخبة المجتمع ومثقفوه الذين يتبنون الفكر العقلاني ويحاربون الغوغاء (كل من يخالفهم) والحال أن العكس هو الصحيح.
في مداخلة متلفزة لأحد الذين يمجدون روسيا ويصورونها على أنها البطل الوحيد القادر على هزيمة الأمريكيين الأشرار، وهو كان يدافع عما يفعله بوتن في أوكرانيا وما فعله في سوريا، قدم المتحدث وهو يمثل النظام في الجزائر، نموذجاً حياً لهذا التناقض الذي وقعت في الشعوب.
جزء كبير من الشعب الجزائري متأثر بالفكر الاشتراكي الذي يمجد روسيا والصين منذ زمن الاتحاد السوفياتي ويتم حشو عقولهم بالشعارات والأفكار البائسة التي أكل عليها الدهر وشرب ولا تسمن ولا تغني من جوع. وطبعا يتم تغليف ذلك بخطاب بنصرة فلسطين، بينما عسكر الجزائر لم يقدموا شيئا نافعا للفلسطينيين بل يستغلون قضيتهم لحشد الجماهير المحبة فعلا لفلسطين وقضيتها.
عسكر الجزائر يخدرون الشعب بهذه الطريقة ويجهلونه ولا يتوقفون عن تمجيد روسيا والصين ويضحكون على عقول الشعب المسكين. نعم هذه هي بالضبط أساليب الشيوعيين وأتباعهم السياسيين: الانقضاض على القضايا التي تستثير عواطف الشعوب لاستغلالهم والسيطرة عليهم.
لقد أضاعوا كل التضحيات التي قدمها الشعب الجزائري في سبيل الحرية والاستقلال واستولوا على مصيره وثرواته. يضحكون عليه بأيديولوجية بائسة بينما يتركونه جاهلا فقيرا ويستمتعون هم بثروات هائلة. وتجدهم يصطفون مع كل القتلة والمجرمين في العالم باسم محاربة أمريكا، ومع كل الطغاة العرب باسم التضامن العربي، والمقصود التضامن بين الحكام مغتصبي السلطة.
والملفت في المجتمع الجزائري وجود فئة معادية للعسكر، لكن من منطلق ضيق، فئوي، انفصالي، متعصب يكاد يكون عنصرياً قبائلياً. ويعزز هذا المنطلق الاحتقان بين المكون العربي والمكون البربري أو الأمازيغي، لدرجة تشتت جهود تحرر الشعب من الاستبداد العسكري الذي يعاني منه الجميع. ويزداد الاحتقان بفعل فاعل، لجعل هذا الاختلاف محور الصراع في البلاد، ليبدو حكم العسكر، أتباع روسيا والصين، هو الطريق الوحيد للحفاظ على وحدة الوطن، ووجوده.

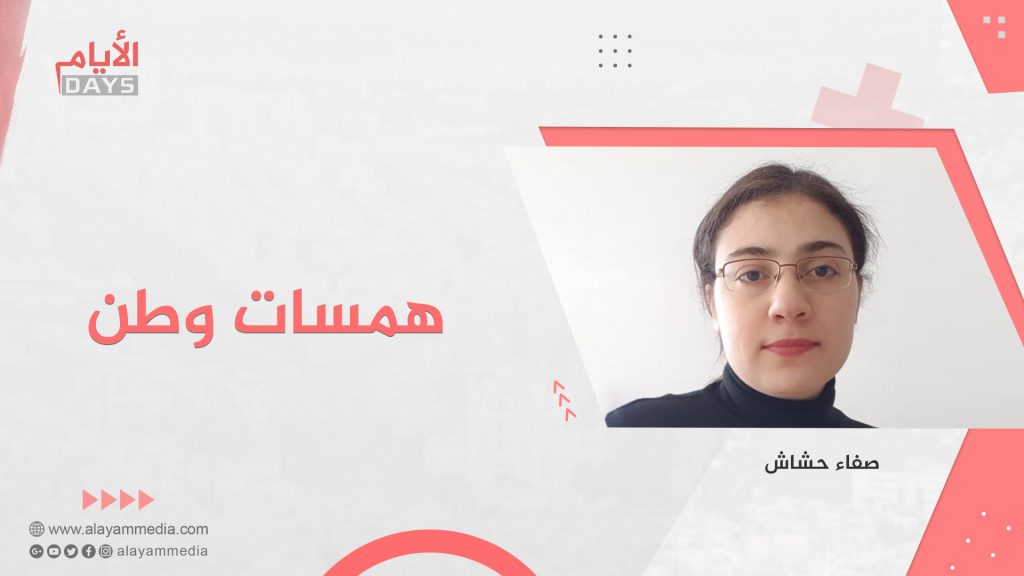



Comments are closed for this post.