قد تكون الفوارق عديدة، في الكمّ كما في النوع، بين نجاح مجرم حرب مثل رفعت الأسد في مغادرة الأراضي الفرنسية وكأنه سائح طيب بريء نظيف اليد، رغم مساءلات قضائية جدّية وملموسة كانت تفترض التحفظ عليه ومنعه من السفر؛ وبين نجاح تماسيح فساد وأبناء استبداد مثل جمال وعلاء مبارك، في تبرئة ساحتهما من كلّ سوء أمام القضاء الأوروبي، مؤخراً. والأرجح أنّ القواسم المشتركة بين الملفين ليست أية نظرية مؤامرة حول فساد القضاء في الحالتين، أو تواطؤ القضاة مع أجهزة سياسية وأمنية عليا في فرنسا أو سويسرا أو الاتحاد الأوروبي؛ فالمنطق، وحيثيات وقائع مختلفة مترامية الأطراف والمحتويات، تحثّ على استبعاد فرضيات كهذه، من دون أن تنفيها قطعياً غنيّ عن القول.
وقد يتوفر قاضٍ فرنسي يساجل (بعد أن يشترط إغفال اسمه، بالطبع) أنّ الأسد كان بالفعل قيد المحاكمة في قضايا عديدة، لكنّ أياً منها لم يقترن بإجراء قانوني يمنعه من مغادرة فرنسا، أو يصادر جواز سفره مثلاً (والنكتة، هنا، أن يحمل جواز سفر واحداً يتيماً، وهو شقيق حافظ الأسد وعمّ بشار الأسد والقائد السابق لوحدات «سرايا الدفاع» الأشدّ بطشاً، وأحد أكثر مرتكبي مجزرة حماة 1982 دموية وهمجية وتعطشاً للدماء). وليس مستبعداً أن يتوفر قاضٍ سويسري يتذرّع بأنّ ما امتلكه المدعي العام الفدرالي السويسري من وثائق وأدلة لم تكن تكفي لإدانة سوزان وجمال وعلاء مبارك؛ وليس مبدأ استغلال النفوذ، الصريح الواضح المتوفر لدى أسرة حسني مبارك، وثيقة في ذاتها لأنّ أيّ حكم قضائي استناداً إليها لن يصمد أمام أبسط طعن أو استئناف.
كلا القاضيَيْن هلى حقّ بالمعنى القانوني، يتوجب القول، وليس لقاضٍ أوروبي أن يحكم اعتماداً على ضمير تلقائي يدفعه إلى اليقين بأنّ أمثال رفعت وجمال وعلاء يستحقون الإدانة؛ وليس له، على قدم المساواة، أن يستنبط أو يبتكر أو حتى يخترع أيّ عدد من الوثائق والأدلة التي قد تساعده في تحكيم ذلك الضمير والنطق بالإدانة. وهذه بامتياز حال كافكاوية، نسبة إلى فرانز كافكا وعمله الشهير «المحاكمة» حيث دهاليز المحاكم وأقواسها ليست أقلّ من متاهات عويصة، تخصّ المصير والوجود قبل القوانين والحدود. وما خلا تلك السراديب الكافكاوية، ما الذي حال دون صدور قرار من القضاء الفرنسي يمنع الأسد من السفر، أو حجب عن المدعي العام السويسري الحقّ في إلزام الحكومة المصرية بتوفير أيّ وكلّ وثيقة يحتاجها القاضي لإدانة آل مبارك؟
وفي تنزيه القضاء الفرنسي من التواطؤ أو الخضوع لسلطات سياسية أو أمنية، يُشار إلى أنّ المحكمة أخذت بما كان قد أوصى به ممثلو الادعاء العام بحقّ الأسد، في الاتهامات بغسل الأموال المنظم والاحتيال الضريبي والكسب غير المشروع واختلاس أموال الدولة السورية وبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا قيمتها نحو 90 مليون يورو، فحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، وسداد غرامة بقيمة 10 ملايين يورو. في المقابل، ليس أقلّ نزاهة الافتراض بأنّ القضاة الذين أصدروا الحكم كانوا على جهل، في كثير أو قليل، بما توفّر لعموم المواطنين الفرنسيين من معلومات متاحة علانية، وردت في كتب ومذكرات منشورة.
نعرف، كما القضاة عرفوا، أنّ 36 سنة من إقامة الأسد في كنف القوانين والأنظمة الأوروبية، بين سويسرا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا ولوكسمبورغ، بدأت من علاقة وطيدة مع الأجهزة الأمنية في فرنسا بصفة خاصة، وهذه باشرت التنسيق معه منذ الأيام الأولى التي أعقبت وصوله إلى سويسرا، حين زاره في جنيف فرنسوا دوغروسوفر «رجل الظلّ» والمهمات الخاصة في قصر الإليزيه، موفداً خاصاً من الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتيران، حاملاً دعوة للانتقال إلى فرنسا والإقامة فيها. المحطة التالية كانت تقليده وسام الشرف برتبة فارس (بسبب «تقديم خدمات إلى الأمّة»!) على نقيض من يقين الاستخبارات الفرنسية بأنه كان على صلة بقرار اغتيال السفير الفرنسي في بيروت لوي دولامار، خريف 1981.
فهل كانت تلك الملابسات، إذا جازت تسميتها هكذا، كافية للامتناع عن إصدار قرار قضائي بالتحفظ عليه ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية؟ بالمعنى الكافكاوي يمكن للإجابة أن تعتمد هذا الاعتبار، ويمكن لها ألا تعتمد أيّ اعتبار؛ إذْ الأصل في المعادلة أنّ الأسد غادر مثل أيّ زائر سائح نظيف اليد بريء الساحة.
عالية التماثل، أياً كانت الاختلافات والتمايزات، ظلت علاقات آل مبارك الاقتصادية والمالية والاستثمارية والمصرفية مع أوروبا والولايات المتحدة وجُزُر الأمان الضريبي هنا وهناك في العالم؛ لأنها إنما تبدأ من موقع الأب حسني مبارك في رئاسة مصر، بما تعنيه عربياً وإسرائيلياً وإقليمياً ودولياً، وتمرّ استطراداً بما كانت الديمقراطيات الغربية، وما تزال، تفرده للطغاة وساسة الاستبداد والفساد، تحت مسمى «الحفاظ على الاستقرار»؛ وليس لها أن تنتهي عند المغانم التي تكسبها جراء هذه «الصداقة» مصارفُ وصناعات سلاح واستثمارات ذات عيار ثقيل في أوروبا. فهل من عرق جبين جمال وعلاء أنهما يستردان اليوم مبلغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار) كان الادعاء العام السويسري قد جمدها؟
وهذه، وسواها، عناصر تتكئ أصلاً على حقيقة أنّ انقلاب عبد الفتاح السيسي ليس معادياً لآل مبارك، ولا للفساد والاستبداد استطراداً؛ ولهذا فالمحاكمة الوحيدة التي خسرها آل مبارك كانت قضية القصور الرئاسية، وتلك تمت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. ولم يكن عسيراً على أجهزة السيسي، لو شاءت إلحاق الأذى بآل مبارك، أن ترسل إلى القضاء السويسري والمحكمة العامة الأوروبية ملفات شركة «العاشر من رمضان للإنشاءات» التي كان جهاز الكسب غير المشروع المصري يحقق فيها، ويسندها بلاغ رسمي من النائب العام وتقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات. صحيح أنّ القضاء المصري نظر في الملف، غير أنّ إحالته إلى قضاء أوروبي كان من المتوقع أن يتخذ وجهة أخرى أكثر جدّية ورصانة.
وإذا كان مستقبل رفعت الأسد في سوريا لا ينذر بالكثير، ما خلا المزيد من الاستثمارات في أعمال المافيا ذاتها التي كدّست ثرواته داخل سوريا وخارجها؛ فإنّ مستقبل جمال مبارك في حياة مصر لا يبدو بالضآلة ذاتها، خاصة بعد استقباله من رئيس الإمارات محمد بن زايد تحت ذريعة تقديم العزاء. وقد يؤخذ في الاعتبار أيضاً واقع النوستالجيا إلى عهد مبارك لدى بعض أبناء مصر، سواء على سبيل التذمر من نظام السيسي أو ضمن انحياز بعض شرائح الطبقة الوسطى إلى منظومة سالفة اختلطت فيها برامج جمال عبد الناصر وأنور السادات ومبارك نفسه. وكما خال بعض المصريين أنّ السيسي هو المهرب من الإخوان المسلمين، قد يقع أولئك أنفسهم، ومعهم فئات جديدة، في الاستيهام ذاته: الفرار من السيسي بالرجوع إلى آل مبارك!
ولأنّ المؤسسة العسكرية هي التي تحكم مصر منذ سنة 1952، ولم تُكسر هذه القاعدة جوهرياً حتى خلال الفترة القصيرة التي شهدت رئاسة محمد مرسي؛ فإنّها، مثلما قدّمت محمد نجيب وعبد الناصر والسادات ومبارك ومحمد حسين طنطاوي والسيسي، يمكن أن تقدّم مشيراً ما، قابعاً اليوم في الظلّ، ينتظر ساعة الانقضاض عبر انقلاب يسوق الذرائع ذاتها التي اعتُمدت، أو تمّ تلفيق بعضها، خلال مليونيات تموز (يوليو) 2013. وليس مستبعداً أن يكون آل مبارك على مبعدة منظورة من هذه النقلة، إذا لم يكونوا في قلبها، وبعض صنّاعها.

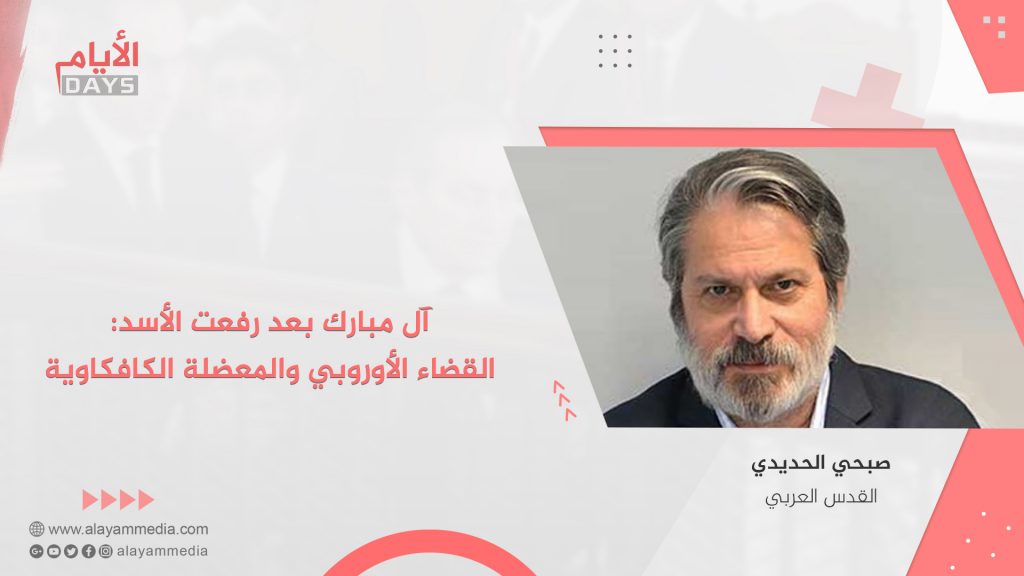



Comments are closed for this post.